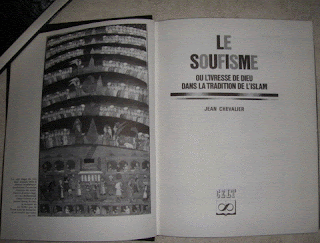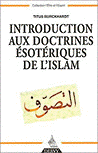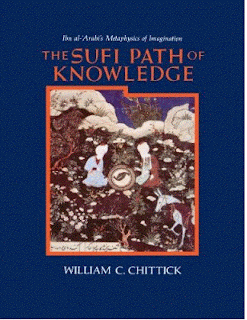النفسية الإسلامية
أو
التصوف
(1)
Spiritisme islamique :
Soufisme
سنعرض تباعا في الحلقات الآتية للتصوف ومفهومه وموقف الإسلام فيه من خلال أهم منظر للفكر السلفي ألا وهو ابن تيمية حتى تكون لنا أفضل فكرة عما أعتبره بحق نفسية إسلامية Spiritisme islamique كما كانت نفسية آلان كارداك أساسا نفسية مسيحية رغم ادعاء مقنن النفسية الحديثة التأسيس لعلم كوني خارج الحدود الضيقة للدين كما هو معروف، يكون جامعا لكل الأديان. نعم، لقد حاول ذلك، ولكن لم ينجح في نظرنا، فبقيت النفسية كما قننها رغم نزعتها الكونية تحافظ على طابع مسيحي.
وسوف تمكننا هذه السلسلة من المقالات من التمهيد للحديث عن النفسية العربية التي تبقي محور بحوثنا في هذه المدونة، لما هناك من ترابط بينها وبين التراث الإسلامي.
وسنرى أيضا من خلال هذه المقالات أن الصوفية أقرب للنفسية في علميتها وكونيتها من النفسية كما قننها كارداك.
ونبدأ اليوم بالتمهيد لهذه السلسلة بتقديم المراجع الهامة في هذا الميدان باللغة العربية والتي تعني من قريب أو من بعيد بموضوعنا؛ وهي تنضاف إلى ما وقع ذكره سابقا من مراجع سواء بالعربية أو بالفرنسية :
مراجع في التصوف
(أو النفسية الإسلامية)
Bibliographie soufie
(ou spirite musulmane)
كتب في التصوف :
ابن عربي (أبو بكر محمد بن علي) :
* رسائل _ نسخة مصورة بالأوفست في دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة سنة 1361 هجرية بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدآباد الدكن. الطبعة الأولى.
* فصوص الحكم _ طبعة دار لبنان، بيروت، بتعليق د. أبو العلا عفيفي.
* الفتوحات المكية _ طبعة سنة 1392 هجرية بالقاهرة، تحقيق د. عثمان يحي ومراجعة د، إبراهيم مدكور، في ثلاثة مجلدات.
ابن الفارض (شرف الدين أبي حفص عمر) :
* الديوان _ طبعة مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان سنة 1972 مسيحية، القاهرة.
ابن قيم الجوزية (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم أو...) :
* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين _ تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة السنة المحمدية، سنة 1375 هجرية، ثلاثة مجلدات.
أبو طالب المكي (محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي) :
* قوت القلوب في معاملة المحبوب _ طبعة مصطفى الحلبي، سنة 1381 هجرية، القاهرة، مجلدين.
* علم القلوب _ الطبعة الأولي، سنة 1384 هجرية، نشر مكتبة القاهرة، مصر.
أبو الفيض (السيد محمد أبو الفيض المنوفي الحسيني) :
* التمكن في شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي _ طبعة دار نهضج مصر، القاهرة، سنة 1969 مسيحية.
* جمهرة الأولياء _ الجزء الأول، طبعة مؤسسة الحلبي بمصر، سنة 1387 هجرية.
أبو القاسم القشيري (عبد الكريم بن هوازن) :
* الرسالة القشيرية في علم التصوف _ الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، سنة 1972 مسيحية.
أبو نصر السراج (عبد الله بن علي الطوسي السراج) :
* اللمع _ تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، طبعة دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، سنة 1380 هجرية.
الجيلاني (أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي) :
* الفتح الرباني والفيض الرحماني _ طبعة دار العلم للجميع، سنة 1392 هجرية.
* الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية _ طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 1375 هجرية.
الجيلي (عبد الكريم بن ابراهيم) :
* الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل _ شركة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية، سنة 1375، القاهرة.
الحارث المحاسبي (أبو عبد الله الحارث بن أسد) :
* الرعاية لحقوق الله _ مراجعة وتقديم عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، طبعة دار الكتاب العربي بمصر.
السهروردي (عبد القادر عبد الله) :
* عوارف المعارف _ دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1966 مسيحية.
عبد الحليم محمود :
* المنقذ من الضلال للغزالي مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي _ دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الثانية، سنة 1394 هجرية.
الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد) :
* إحياء علوم الدين _ تخريج العلامة أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، طبعة دار المعرفة ببيروت.
* مكاشفة القلوب المقرب إلى حسرة علام الغيوب في علم التصوف _ طبعة محمد علي صبيح.
* منهاج العابدين، ومعه الكشف والنبيين، وبداية الهداية _ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، سنة 1384 هجرية.
الكلاباذي (أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري) :
* التعرف لمذهب أهل التصوف، طبعة سنة 1352 هجرية، مطبعة السعادة بمصر.
المقدسي (أبو الفضل بن طاهر) :
* صفوة التصوف _ مطبعة دار التأليف بمصر، سنة 1370 هجرية.
الهجويري (أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الغزنوي) :
* كشف المحجوب للهجويري _ دراسة وترجمة وتعليق د. إسعاد عبد الهادي قنديل، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، سنة 1394 هجرية.
كتب حول التصوف :
إبراهيم إبراهيم هلال :
* ولاية الله والطريق إليها _ طبعة المدين، القاهرة.
ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن) :
* تلبيس إبليس _ طبعة دار الوعي العربي، بيروت.
أبو الحسن الندوي :
* ربانية لا رهبانية _ دار الفتح، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1388 هجرية.
أبو الوفاء الغنيمي :
* ابن سبعين وفلسفته الصوفية _ دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولي، سنة 1973 مسيحية.
أحمد توفيق عاد :
* التصوف الإسلامي _ مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 1970 مسيحية.
البقاعي (برهان الدين) :
* تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي _ تحقيق د. عبد الرحمن الوكيل، طبعة السنة المحمدية بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1372 هجرية.
الجرجاني (الشريف علي بن محمد) :
* التعريفات _ طبعة الحلبي، القاهرة، سنة 1357 هجرية.
زكي مبارك :
* التصوف الإسلامي _ طبعة المكتبة العصرية، بيروت.
* الأخلاق عند الغزالي _ طبعة الشعب بالقاهرة، سنة 1390 هجرية.
سميح عاطف الزين :
* الصوفية في نظر الإسلام _ دار الكتاب اللبناني، بيروت، سنة 1969.
الشيبي (د. كامل) :
* الصلة بين التصوف والتشيع _ مطبعة الزهراء، بغداد، سنة 1383 هجرية.
صلاح عزام :
* أقطاب التصوف الثلاثة _ طبعة الشعب، القاهرة، سنة 1388 هجرية.
عبد الباري الندوي :
* بين التصوف والحياة _ مكتبة دار الفتح، دمشق، سنة 1383 هجرية، الطبعة الأولي.
عبد الحفيظ محمد هاشم :
* أخبار الحلاج، ومعه الطواسين، ومجموعة من شعر الحلاج _ مكتبة الجندي بمصر، سنة 1970 مسيحية.
عبد الرحمن الوكيل :
* هذه هي الصوفية _ مطبعة السنة المحمدية بمصر، الطبعة الثالثة، سنة 1375 هجرية.
عبد القادر محمود :
* الفلسفة الصوفية في الإسلام _ دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولي، سنة 1966 مسيحية.
قاسم غني :
* تاريخ التصوف الإسلامي _ ترجمة د. أحمد ناجي ود. محمد مصطفى حلمي، طبعة النهضة المصرية، سنة 1970 مسيحية.
محمد جلال شرف :
* التصوف الإسلامي في مدرسة بغداد _ طبعة دار الطباعة الجامعية، الإسكندرية، سنة مسيحية 1972.
محمد الغزالي :
* الجانب العاطفي في الإسلام _ دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1382.
محمد مصطفى حلمي :
* الحياة الروحية في الإسلام _ المطبعة الثقافية، القاهرة، سنة مسيحية 1970.
* ابن الفارض والحب الإلهي _ دار المعارف بمصر، سنة 1971 مسيحية.
نيكلسون (راينولد أ.) :
* الصوفية في الإسلام _ ترجمة نورالدين شريبة، طبعة الخانجي بمصر، سنة 1371 هجرية.
* في التصوف الإسلامي وتاريخه _ ترجمة د. أبو العلا عفيفي، طبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، سنة 1366 هجرية.
كتب تراجم وسير :
ابن الأثير (عز الدين بن الحسن علي بن أبي الكرم) :
* الكامل في التاريخ _ دار صادر، بيروت، سنة 1386 هجرية.
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي) :
* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة _ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، نشر وزارة الإرشاد القومي بمصر.
ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني) :
* الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة _ طبعة حيدر آباد، الهند، سنة 1348 هجرية.
ابن رجب (زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن) :
* ذيل طبقات الحنابلة _ تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة السنة المحمدية بالقاهرة، سنة 1372 هجرية.
ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي) :
* شذرات الذهب في أخبار من ذهب _ طبعة المكتب التجاري، بيروت.
ابن كثير (الحافظ عماد الدين) :
* البداية والنهاية _ نسخة مصورة من الطبعة الأولى عن مكتبة دار المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض، سنة 1966 مسيحية.
ابن الملقن (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصري) :
* طبقات الأولياء _ تحقيق نور الدين شريبة، طبعة دار التأليف، الطبعة الأولى، سنة 1393 هجرية.
ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق) :
* الفهرست _ المطبعة الرحمانية بمصر، سنة 1348 هجرية.
ابن هشام (أبو محمد عبد الله) :
* السيرة النبوية _ تعليق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة مكتبة الأزهر.
أبو الفيض (محمود) :
* جمهرة الأولياء وأعلام التصوف _ طبعة الحلبي بمصر، الطبعة الأولى، سنة 1387 هجوية.
أبو نعيم (أحمد بن عبد الله الأصبهاني) :
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء _ مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولي، سنة 1391 هجرية.
أبو يعلى (القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى) :
* طبقات الحنابلة _ تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة السنة المحمدية.
البستي (محمد بن حبان) :
* مشاهير علماء الأمصار _ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، سنة 1379 هجرية.
جرجي زيدان :
* تاريخ آداب اللغة العربية _ تعليق شوقي ضيف، طبعة دار الهلال، سنة 1957.
خير الدين الزركلي :
* الأعلام _ الطبعة الثالثة، سنة 1389 هجرية، دار العلم للملايين، بيروت.
الذهبي (أبو علد الله محمد) :
* تذكرة الحفاظ _ مصورة عن الطبعة الثالثة عن مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، سنة 1376 هجرية.
السبكي (عبد الوهاب علي) :
* طبقات الشافعية الكبرى _ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1383.
السلمي (أبو عبد الرحمن) :
* طبقات الصوفية _ دار الكتاب العربي بمصر، سنة 1372 هجرية.
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) :
طبقات الحفاظ _ تحقيق علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1393.
الشعراني (عبد الوهاب بن أحمد) :
* الطبقات الكبرى (أو : لواقح الأنوار في طبقات الأخبار) _ مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة.
الشوكاني (محمد بن علي) :
* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع _ مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، سنة 1348 هجرية.
الكتبي (محمد بن شاكر) :
* وقيات الوفيات _ مطبعة السعادة بمصر.
المناوي (عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين) :
* الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية _ القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1357 هجرية.
كتب أخرى :
ابن خلدون (عبد الرحمن) :
* المقدمة لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر _ دار المصحف، القاهرة.
ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية أو...) :
* طريق الهجرتين وباب السعادتين _ دار الطباعة المصرية، القاهرة، الطبعة الأولي، سنة 1357 هجرية.
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان _ تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة الحلبي، سنة 1381 هجرية.
* حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح _ طبعة على صبيح المدني، القاهرة، سنة 1384 هجرية.
* الروح _ طبعة محمد علي صبيح، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 1386.
* روضة المحبين ونزهة المشتاقين _ مكتبة الجامعة، القاهرة، سنة 1973 مسيحية.
أحمد أمين :
* ظهر الإسلام _ مكتبة النهضة بمصر، سنة 1966 مسيحية.
أحمد بن حنبل (أحمد بن محمد بن هلال) :
* الزهد _ مطبعة أم القرى، العربية السعودية.
جولدتسيهر (إنياس) :
* العقيدة والشريعة _ تعريب د. محمد يوسف موسى و د، علي حسن عبد القادر، نشر دار الكتب الحديثة بمصر، الطبعة الثانية.
سعد الدين التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) :
* شرح المقاصد _ مطبعة محمرم أفندي، سنة 1917 مسيحية.
الشاطبي (إبراهيم بن موسى بن محمد) :
* الموافقات في أُصول الشريعة _ دار الكتب العلمية، بيروت.
صديق حسن خان :
* الدين الخالص _ مكتبة دار العروبة، القاهرة، سنة 1379.
علي محفوظ :
* الإبداع في مضار الابتداع _ المكتبة المحمودية التجارية، القاهرة.
عياض (القاضي) :
* الشفا بتعريف حقوق المصطفى _ طبعة عبد الحميد حنفي، طبعة أولى.
محمد خليل هراس :
* دعوة التوحيد، أصولها وأدوارها ومشاهير علمائها _ مطبعة عاطف بطنطا.
محمد عبده :
* رسالة التوحيد _ طبعة الشعب، سنة 1390 هجرية.
الفقي (محمد) :
التوسل والزيارة _ مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى، سنة 1388 هجرية.
دائرة المعارف الإسلامية _ طبعة الشعب، سنة 1388 هجرية.